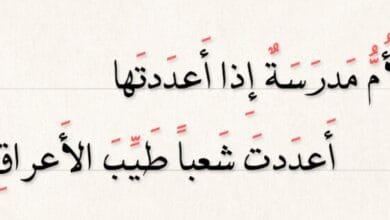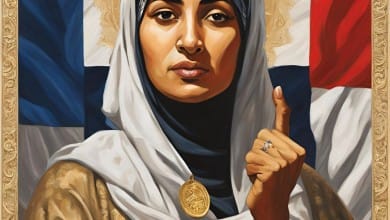المرأة، بمثابرتها وحرصها واهتمامها بالتفاصيل، هي مترجمة ممتازة،
وللمرأة موهبة في اللغة والتعبير مفيدة في الترجمة وفي الكتابة بوجه عام.
أنا أستاذ الفلسفة بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية. أنظر إلى نفسي على أنني كاتب ومؤلف. أحاول أن أسهم في المجال الثقافي العام، بكتب ومقالات، وبالحضور في الندوات وكافة المناسبات الثقافية. الفلسفة هي شغفي، ثم تاريخ الأديان، ثم الاقتصاد السياسي، ثم السوسيولوجيا.
هل لديك هوايات مفضلة:
كان لدي العديد من الهوايات في صغري مثل التنس والصيد، أما الآن فلا أجد وقتاً.
عرفنا على الأعمال الثقافية /المترجمة الخاصة بك:
ترجمت حتى الآن كتابين. الأول هو “نظريات الأيديولوجيا” Theories of Ideology، تأليف يان ريمان Jan Rehmann، وصدر عن المركز القومي للترجمة في يناير 2023. والثاني هو “دليل كيمبردج في تاريخ الفلسفة العربية”، وسوف يظهر خلال أشهر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للطباعة والنشر.
احكي لنا قصتك مع الكتابة/الترجمة:
بدأت أكتب منذ أن كنت في المرحلة الثانوية، لكنني كنت أكتب لنفسي، فقد كنت أقرأ كثيراً، والذي يقرأ كثيراً يشعر بالحاجة إلى أن يكتب شيئاً. وعندما دخلت كلية الآداب كنت أكتب في مجلات الحائط. وبعد تخرجي بدأت أكتب في مجلة كانت تصدر من الإسكندرية اسمها “تحديات ثقافية”، ومؤسسها هو الشاعر السكندري الأستاذ مهدي بندق. وقد شجعني على الكتابة وتعلمت منه الكثير. كانت كتابتي أكاديمية نظراً لأنني كنت أكتب في رسالة الماجستير، وكنت معتاداً في مرحلة الليسانس على كتابة الأبحاث، لكن الكتابة للجمهور شيء آخر في حاجة إلى تدريب، والكتابة الفكرية لجمهور من المثقفين في حاجة إلى توجيه وتدريب، وهذا ما قدمه لي الأستاذ مهدي بندق.
لماذا اخترت الترجمة لتصبح الوعاء الثقافي الذي تنشر الفكر من خلاله؟
سوف أتكلم في البداية عن الترجمة ثم عن توجهي للترجمة في السنوات الأخيرة. الترجمة تأليف غير مباشر. والترجمة إلى اللغة العربية بوجه خاص تحتاج إلى جهد كبير وهي شاقة جداً، ذلك لأن المترجم ينقل نصاً من منظومة لغوية إلى منظومة أخرى مختلفة عنها تماماً. هناك فرق بين الترجمة من لغة أوروبية إلى لغة أوروبية أخرى، والترجمة من لغة أوروبية أو أي لغة إلى العربية، لأن المترجم ينقل النص إلى ثقافته وأساليبها في التعبير. إنه يعيد سبك الجملة وصياغتها ويعيد ترتيب الكلمات من حيث التقديم والتأخير، كي يُخرج نصاً مفهوماً في اللغة العربية، لا مجرد نص مترجم منقول كما هو. ومن صعوبات الترجمة، المصطلحات، فهي حتى الآن غير مستقرة في كل التخصصات، والكثير منها غير مترجم إلى العربية ويترجمه المترجم لأول مرة.
أما عن اتجاهي للترجمة، فالحقيقة أنني كنت على الدوام أؤلف كتباً وأبحاث وأكتب مقالات، لكنني وجدت أن ترجمتي للنصوص في كتبي ليست سيئة بل جيدة، ووجدت من أصدقائي من يقترح عليّ أن أترجم، خاصة وأن مجال الترجمة الآن يشهد دخلاء وهواه وغير متخصصين في الكتب التي ترجموها، ولاحظت مدى السوء في بعض الترجمات، وعزفت عن قراءة أي كتاب مترجم. وقلت لنفسي لأخوض التجربة وكانت ناجحة. لم أتجه إلى الترجمة في بداية حياتي الأكاديمية، فقد كنت مشغولاً بالماجستير والدكتوراه وأبحاث الترقية حتى حصلت على الأستاذية. وبعدها فكرت في الترجمة وبدأت في السنوات الخمس الأخيرة. كنت مقتنعاً دائماً أن المؤلفات أهم، وأنه يجب أن تكون لدي مؤلفات كثيرة قبل أن أبدأ في الترجمة، لأنني أرى العديد من الأساتذة في كل التخصصات امتهنوا الترجمة ولم يعدوا يؤلفون، والبعض منهم غير معروف على أنه مؤلف ومعروف على أنه مترجم، والبعض منهم أعماله مجرد أبحاث ترقية والباقي كتب مترجمة. لم أرد أن أكرر هذه الظاهرة، فالتأليف هام للغاية ويجب أن تسبق المؤلفات الترجمات.
شاركنا اقتباس من الأعمال التي قمت بترجمتها:
النص التالي هو الفقرة الأولى من مقدمة كتاب “دليل كيمبردج في تاريخ الفلسفة العربية” Cambridge Companion to Arabic Philosophy قيد النشر:
ترجع بداية تاريخ الفلسفة في الحضارة العربية الإسلامية إلى بداية ظهور الإسلام نفسه. فقد كان الجدل اللاهوتي المثير فلسفياً حاضراً خلال القرنين الأولين من ظهور الإسلام في 622 م. وفي نفس ذلك الوقت كانت بعض أهم النصوص العلمية والطبية والفلسفية اليونانية تُدْرَس وتُوَظَّف في التراث السرياني، مع المنطق الأرسطي الذي كان يُستخدم في الجدل اللاهوتي [المسيحي]. ومع القرن الثالث الهجري، التاسع الميلادي، ظهرت حركة ترجمة كبيرة متمركزة في بغداد وازدهرت للغاية هناك. واستجابة لذلك، بدأ الفلاسفة المسلمون والمسيحيون واليهود الذين يكتبون بالعربية في تقديم إسهامات هامة لتراث التفلسف، والذي ظل حياً حتى الآن. وقد كان قصر الخليفة من أهم الأماكن التي دار فيها الجدل والنزاع والتنافس بين أصحاب الديانات الثلاث حول المنطق والنحو واللاهوت والفلسفة. وقد تضمن هذا التراث الجدلي نقاشاً مركزاً وأصيلاً وحاد الذكاء لكل القضايا الفلسفية القديمة، التي كانت خمراً عتيقة لكن في زقاق جديدة، مثل أصل الكون وبنائه، وطبائع العناصر في العالم الفيزيائي، وعلاقة الكائنات البشرية بالألوهية المفارقة، ومبادئ الميتافيزيقا، وطبيعة المنطق، وأسس المعرفة، وسبيل الوصول إلى الحياة الأخلاقية الفاضلة.
كيف تعرّف فعل الترجمة من منظورك؟ كيف تباشر ترجمة نص ما؟
الترجمة هي نقل نص من ثقافة إلى أخرى، ومن عالم فكري وحضاري إلى عالم فكري وحضاري آخر ومختلف. وهي بذلك تتضمن عملية تبيئة وتسكين للنص داخل عالم اللغة العربية وثقافتها وأطرها الفكرية. إنها عملية ميلاد جديدة للنص الأصلي، إعادة إنتاج له وفق شروط العربية. والنص المترجم يجب أن يكون مفهوماً بالعربية كما لو كان مكتوباً بالعربية.
وفي ترجمتي لكتاب ما، أقرأه كله أولاً، لأفهمه وأعرف أسلوب الكاتب، ومعي القلم، أضع خطاً تحت العبارات الطويلة التي ستكون صعبة في الترجمة، وخطاً تحت الاستطرادات والنعوت الكثيرة التي تعيق انسيابية الجملة عندما تترجم، وأكتب في هوامشه ترجمات للمصطلحات والكلمات الصعبة. وأحياناً ما أكتب تعليقات أضعها أثناء الترجمة في الهامش. وكثيراً ما أتذكر مصطلحاً تمت ترجمته من قبل فأكتب ملحوظة لنفسي كي أرجع إلى الترجمة السابقة للمصطلح.
وترجمة الكتاب أشبه بنظام عسكري، إذ يجب على المترجم ألا يغيب معه الكتاب وأن يكون ملتزماً بموعد نهائي، وبالتالي عليه الالتزام بعدد معين من الصفحات كل يوم، وإلا تأخر، وإذا فات يوم دون ترجمة يجب أن أعوضه في اليوم التالي، وفي النهاية يأتي دور المراجعة، وهي لا تقل أهمية عن الترجمة ذاتها، فالمراجعة هي التي تضبط النص الضبط النهائي، وهي التي يضع فيها المترجم نفسه مكان القارئ ويحكم على النص المترجم. وفي هذه المراجعة تتم تعديلات كثيرة وتعاد صياغة الكثير من العبارات، وتتم كتابة تعليقات وتوضيحات وتعريفات في الهامش.
ماهي أهم الأعمال التي ساهمت في تكوين رؤيتك الفكرية/توجهك في الترجمة؟
عندما كنت في المرحلة الثانوية قرأت معظم ترجمات عادل زعيتر: ترجماته لروسو: العقد الاجتماعي، إميل أو التربية، فولتير: كانديد، وإميل لودفيج: بسمارك، نابليون، النيل حياة نهر، إرنست رينان: ابن رشد والرشدية، جوستاف لوبون: حضارة العرب، روح الثورات والثورة الفرنسية، ولمونتسكيو: روح الشرائع. كنت أقرأ كل هذه الكتب لأنها ترجمة عادل زعيتر بصرف النظر عن مؤلفيها، كنت أقرأها لأستمتع بترجمة عادل زعيتر، وتعلمت منه كيف تنقل الجملة إلى العربية كما لو كانت مؤلفة. ثم بعد ذلك قرأت ترجمات فؤاد زكريا لهربرت ماركوة وزكي نجيب محمود لجون ديوي وحسن حنفي لسبينوزا، وترجماتهم رائعة واحترافية لأنهم كانوا متخصصين في الحقول التي ترجموا فيها وترجماتهم دقيقة ورصينة. كانت هذه المؤلفات هي التي كونتني فكرياً.
شيء هام أود أن ألفت النظر إليه. المدرسة المصرية في الترجمة هي أفضل مدرسة على الإطلاق. ليس هذا نزعة شوفينية أو تعصباً قومياً لكنها الحقيقة. الكثير من الترجمات الشامية والمغاربية لا تعجبني، وهي ليست انسيابية وسلسلة مثل الترجمات المصرية. لكن هناك ترجمات مصرية سيئة أيضاً، بالغة السوء وخاصة في الآونة الأخيرة.
هل تمثل مجمل أعمالك المترجمة مشروع ما؟
إنني أختار في ترجماتي المؤلفات المتخصصة، التي أشعر أنني الأقدر على ترجمتها، والتي أثق أنني سأخرجها بصورة جيدة لا يستطيع أن ينافسني فيها أحد. فلما كنت متخصصاً، فإن ترجمة الكتب المتخصصة في الفلسفة هي الأنسب لي. وعندما اخترت “دليل كيمبردج في تاريخ الفلسفة العربية” لأترجمه، فقد كان هدفي هو أن أقدم للقارئ العربي عملاً غربياً في الفلسفة العربية الإسلامية، بهدف تعريف القارئ بنوعية الكتابة الأكاديمية الغربية فيها ومدى ما وصل إليه البحث الأكاديمي فيها، وأقدم له كيف فهم الباحثون الغربيون الفلسفة العريية الإسلامية وكيف يبحثون فيها وما هي مناهجهم وأدواتهم في دراساتها، وهو نوع من اكتشاف صورة الذات في مرآة الآخر.

هل هناك أعمال جديدة؟ هل تستكمل المشروع؟ أم أن هناك مشروع جديد؟
أفكر حالياً في ترجمة كتاب من كلاسيكيات الفكر السوسيولوجي، فهذا المجال يشهد نقصاً شديداً. هدفي هو أن أقدم للقارئ العربي عملاً من تأليف أحد رواد علم الاجتماع الغربيين،كي يتعرف على حقيقة الممارسة العلمية وكيفية إجراء التحليل السوسيولوجي. فقد درسنا وقرأنا كثيراً في النظريات السوسيولوجية، لكن ينقصنا التعرف على التحليلات السوسيولوجية التي قدمها الرواد، لنتعرف على العلم في الممارسة والتطبيق.
في رأيك، ما دور المرأة في العمل الثقافي/الفكري وطبعاً في مجال الترجمة؟
للمرأة دور هام وكبير في العمل الثقافي والفكري بوجه عام والترجمة بوجه خاص. المرأة بمثابرتها وحرصها واهتمامها بالتفاصيل هي مترجمة ممتازة، وللمرأة موهبة في اللغة والتعبير مفيدة في الترجمة وفي الكتابة بوجه عام. أعرف مترجمات كثيرات وقرأت لهن، وبوجه عام فإن أعمال المترجمات على درجة عالية من الجودة فالمترجمة دائماً ما تكون حريصة ودقيقة ولا يمكن أن تكون مستهترة ومتعجلة مثل بعض الرجال المترجمين. كما أن اختيارات المترجمات في الكتب ممتازة، وترجمة كتاب هي تقديمه للقارئ العربي، ولذلك فالاختيار هام للغاية واختيارات المرأة ضرورية.
في رأيك، هل وفّى الأدب/السينما للمرأة حقها وتقديرها؟
قد تظهر المرأة في الأدب بأفضل مما تظهر في السينما، وفي بعض الأعمال الأدبية طبعاً لا بوجه عام. أما السينما فإن صورة المرأة ليست جيدة، ربما لأن السينما تعكس صورة المجتمع كما هي أو لدواعي تجارية.
ماذا تحب ان توجه في كلمة لجمهورك من متابعي فكرك ومن قارئي ترجماتك؟
أحيي كل قرائي والذين يتابعونني في كل الوسائل الورقية والإلكترونية، وأقول لهم انتظروا المزيد من الأعمال القادمة قريباً، المترجمة والمؤلفة، والأعمال المؤلفة جديدة لم يسبق أن كتب فيها أحد من قبل وستكون مفاجأة.
وختاماً، ما رأيك في مجلة الجميلات والشرق؟
فكرتها ممتازة وهي ضرورية ومطلوبة الآن، موضوعاتها رائعة وعلى درجة عالية من الوعي ونجحت في الوصول إلى جمهور كبير في وقت قصير، وكُتَّابها على درجة عالية من الثقافة ويختارون موضوعات جديدة جداً. كنا في حاجة إلى مجلة نسائية تغطي موضوعات الأسرة وتكون قريبة من الناس وتعمل على التوعية والتنوير. أتمنى لكم جميعاً كل التوفيق وأنا على يقين من ازدهار وتألق المجلة ومن المزيد من الشهرة والانتشار.